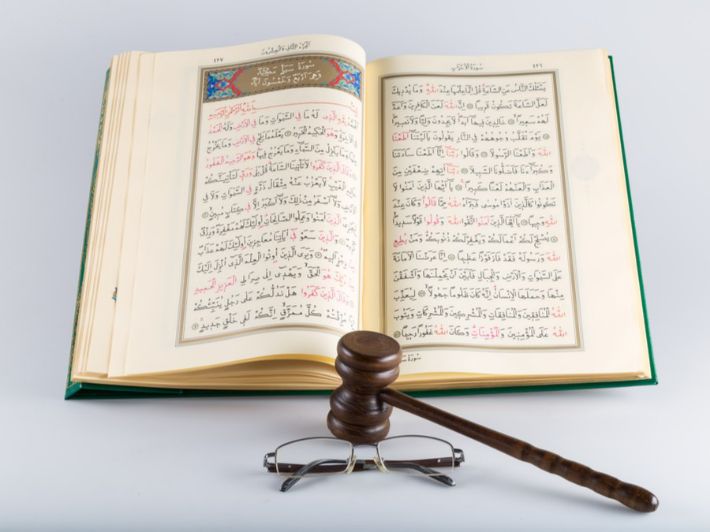يُقسّم جماهير علماء أصول الفقه الحكمَ التكليفيّ إلى أنواعٍ خمسةٍ، هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، وتتعلّق هذه الأوصاف بأفعال المكلّفين،[١] وقد يُطلق الأصوليّون أسماء أخرى على بعض هذه الأنواع، ومنهم من يُقسم النوع الواحد من الحكم التكليفيّ درجاتٍ ويُفّرّق بينها، ومن ذلك: الندوب؛ فقد يُطلق عليه أكثر من اسمٍ، ومن الأصوليين من قسَّمه إلى درجاتٍ ومراتب وفرّق بينها، وفيما يأتي توضيح ما يتّصل بالمندوب، والفرق بينه وبين المستحبّ عند من يرى من العلماء أنّ بينهما فارقًا.
الفرق بين المندوب بالمستحبّ
يرى عددٌ من العلماء أنّ المندوب والمستحبّ ألفاظٌ مترادفةٌ ولا فرق بينهما، ويطلقان على ما أمر به الشرع وطلبه طلبًا غير جازمٍ، ويثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه،[٢] ومن العلماء من جعل المندوب هو الأصل، والمستحبّ قسمٌ من أقسامه، ومن أقسامه كذلك السّنة والنفل،[٣] وفيما يأتي تفصل أقوال العلماء في أقسام المندوب والفرق بينهما.
أقسام المندوب عند العلماء
تعدّدت تقسيمات العلماء لمراتب المندوب، ومعنى كلّ مرتبةٍ وما يترتّب عليها، فيما يأتي بيانٌ لهذه التقسيمات عند علماء المذاهب الأربعة.
أقسام المندوب عند الحنفيّة
قسّم الحنفيّة المندوب إلى أقسامٍ ثلاثةٍ، هي:[٤]
- سّنة الهدي: وهي المرتبة الأولى من مراتب المندوب، ويُقصد بالهدي ما كان من مكمّلات الدين؛ كالأذان والإقامة للصلاة، وأداء الجماعة ونحوها، وحكمها أنّ فاعلها مُثابٌ مأجور، ويترتّب على تركها لومٌ وكراهةٌ.
- النفل: وهو ما يقوم به المسلم ويؤدّيه من العبادات زيادةً على ما فُرض عليه، وقالوا إنّ فاعل النفل مثابٌ، ولا عقاب على تركه للنوافل، إلّا أنّ الأولى له أن يفعلها.
- الزوائد: وهي الأمور المتعلِّقة بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- من حيث هديه وسيرته في اللباس والقيام والقعود ونحو هذه الأفعال، حيث يُثاب فاعلها إذا قصد التّأسي والاقتداء بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- ولا بأس أو حرج على من لم يفعلها.
أقسام المندوب عند المالكيّة
قسّم المالكيَّة المندوب إلى ثلاثة أقسامٍ، باعتبار مدى مواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، وهذه الأقسام هي:[٤]
- السنة: وهي أعلى مراتب المندوب، ويراد بها الأفعال التي واظب النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على فعلها، والتزم أداءها دون أن تكون فرضًا أو واجبًا، ومثالها: صلاة الكسوف، والخسوف، وصلاة العيدين، والوتر، سجود السهو عند المالكيّة، ويكون فاعل السنّة مُثابًا مأجورًا، ولا عقاب على تاركها.
- المستحبّ: وهو ما أمر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بفعله، ورغّب في فعله، وحثّ عليه بذكر ما يترتّب عليه من أجرٍ وثوابٍ، إلّا أنّه لم يواظب على فعله بل فعله لمراتٍ فقط.
- النافلة: ويُعرِّف المالكيّة النافلة بأنّها ما لم يُرغّب النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في أدائه أو يحثّ على فعله بصورةٍ مباشرةٍ، ولم يذكر أنّه داوم على فعله، إلّا أنّه أخبر عمّا فيه من ثوابٍ وأجرٍ، ومن الأمثلة التي يذكرها المالكيّة على النافلة عندهم؛ التيامن في السلام، القراءة مع الإمام، قول آمين بعد قراءة الفاتحة.
المندوب والمستحبّ عند الشافعيّة والحنابلة
لم يُفرّق جمهور العلماء من الشافعيّة والحنابلة بين ألفاظ المندوب، بل جلعوها جميعها مترادفةً وفي مرتبةٍ واحدةٍ؛ فلم يجعلوا كلّ لفظٍ من الألفاظ في مرتبةٍ مستقلَّةٍ، بل إنّ المندوب، والمستحبّ، والسنة، والتطوع والنفل كلّها عندهم في مرتبةٍ واحدةٍ، ولا فرق بينها.[٤]
المراجع
- ↑ محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 385. بتصرّف.
- ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، صفحة 111-113. بتصرّف.
- ↑ حسن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، صفحة 126-127. بتصرّف.
- ^ أ ب ت مريم محمد صالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، صفحة 39-42. بتصرّف.